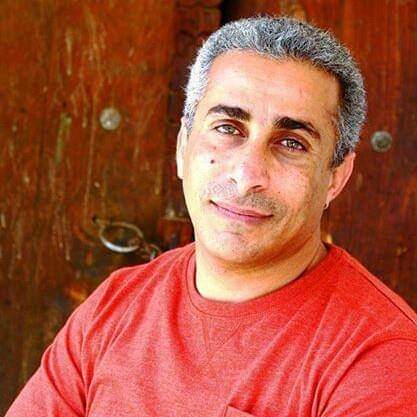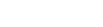ظل السياسي العربي قومياً كان أو يسارياً أو إسلامياً، يؤمن بحتمية النصر لا بواقعيته ومتطلباته. سننتصر لأن ذلك من حتميات التاريخ لا لأننا نمتلك مقومات النصر!
لا تخضع مفاهيم النصر والهزيمة في السياسة العربية للمعايير العقلانية المعهودة.
النصر ليس بالضرورة كسب المعركة، وخسارة الأرض والأرواح ليس بالضرورة هزيمة.
وإذا تم الاعتراف بهزيمة ما فإن هذا الاعتراف يكون مشروطاً بتحفظين كبيرين؛ التحفظ الأول هو إلقاء مسؤوليتها على طرف خارجي (الامبريالية، الاستعمار، أميركا)، والتحفظ الثاني هو البحث عن اسم بديل للهزيمة، فهزيمة 1948 اسمها “النكبة”، وهزيمة 1956 اسمها “العدوان الثلاثي” وهزيمة 67 هي “النكسة”، وهكذا تُوارب الهزيمة، اعتماداً على القدرة السحرية للكلمات.
لكن الانتصار العربي لا يقل غموضاً عن الهزائم، وجميع الانتصارات العربية “الكبرى” هي انتصارات إشكالية يختلط فيها الزهو بالنصر بتجرع مرارة الخسارة.
هل انتصر جمال عبد الناصر، مثلاً، في حرب 1956؟
بكل المقاييس العسكرية انهزم عبد الناصر، فقد احتلت إسرائيل سيناء بسهولة، وسيطرت فرنسا وبريطانيا على كل مداخل قناة السويس، وتكبد الجيش المصري خسائر فادحة في الأرواح والمعدات… ولولا تدخل الاتحاد السوفياتي وأميركا، لكانت القاهرة هي الهدف التالي للحرب. وحتى بعد انسحاب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، أجبرت مصر على دفع ملايين الدولارات، تعويضات لبريطانيا وفرنسا، وأجبرت على إتاحة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية والغربية من دون قيود.
من الناحية الأخرى، استطاعت قوى الاستعمار الجديد (الاتحاد السوفياتي وأميركا) إزاحة قوى الاستعمار القديم (فرنسا وبريطانيا) والحلول محلها عسكرياً واستراتيجياً. وكانت لحظة حرب السويس هي “عصر التدوين” للمعايير العربية المشوشة للنصر والهزيمة. اللحظة التي أسست للمحفوظات السياسية حول كل حرب وكل هزيمة يتجرعها العرب، وأصبحت عبارات مثل ” خسرنا المعركة ولم نخسر الحرب”، و”خسرنا عسكرياً لكننا كسبنا سياسياً”، والنصر المعنوي”، و”النصر الأخلاقي”، و”انتصرنا لأن النظام لم يسقط”… كل هذه المحفوظات والتبريرات تأسست عام 1956 لتصبح إنجيل الانتصارات والهزائم في السياسة العربية حتى اليوم.
لكن ثمن التغطية على الهزيمة هو هزيمة أخرى أشد بشاعة.
ولو كانت السياسة العربية قد اعترفت بهزيمة 56 لتجنبنا هزيمة 67 ، لأن 67 لم تكن سوى تكرار أشد تراجيدية لهزيمة 56. فقد استطاعت إسرائيل احتلال سيناء عام 67 بالسهولة التي احتلتها بها عام 1956. وتمكنت من تدمير الطائرات الحربية المصرية وهي ما زالت على الأرض في 1967، مثل ما استطاعت فرنسا وبريطانيا ذلك في حرب الـ56.
الثمن الغالي لإنكار الهزيمة هو المجازفة بتكرارها بشكل هزلي أو مأساوي.
يستغرب أمين معلوف في كتابه “اختلال العالم” كيف أن عبد الناصر، صاحب أكثر الهزائم العربية إذلالاً، هو البطل الأكثر شعبية عند الجماهير العربية. وكيف أن السادات صاحب الانتصار العسكري العربي الوحيد هو أكثر زعيم مكروه في الشارع العربي.
انهزم عبد الناصر في كل معاركه العسكرية، بما في ذلك حرب اليمن التي تحولت الى مذابح يومية بحق الجنود المصريين وفشل سياسي شامل في التعاطي مع الوضع. لكن النزعة العربية للانتصار الدائم بحثت عن معايير جديدة للانتصار، فصار معيار الانتصار في اليمن هو المحافظة على النظام الجمهوري الوليد، وصار معيار الانتصار في حرب 1967 هو عدم سقوط عبدالناصر، وأصبح معيار انتصار صدام في حرب 1991 أنه ظل حاكماً العراق حتى عام 2003.
الانتصارات العربية قاسية جدا. فما دخل بلد عربي دوامة الانتصارات إلا وأوقع شعبه في هاوية الفقر والحروب الأهلية والاستبداد.
دخل لبنان دوامة الانتصارات عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ذلك الانسحاب الذي حوله “حزب الله” إلى انتصار تاريخي تمكن بموجبه من الاستيلاء على النصر منفرداً، وأيضاً استطاع من خلاله فرض “الاحتلال الداخلي” على لبنان لمصلحة أجندة الحزب والولي الفقيه.
ثم جاء انتصار 2006 بثمن أعلى هو تدمير المدن اللبنانية، وإعادة الاقتصاد عقوداً إلى الوراء. تم تدمير الدولة وخلخلة الاقتصاد، لكن الحزب لم يسقط ولا صواريخه، وهذا، مرة أخرى، هو معيار النصر العربي الأكيد. تراكمت الانتصارات/ الهزائم اللبنانية على “حزب الله”، من الانتصار الطائفي في سوريا إلى الانتصار على العدو السلفي الداخلي، وبعد كل انتصار “تاريخي” ينجرف لبنان أكثر نحو الطائفية والفقر وفقدان السيادة.
إن البلد التالي في حجم الانتصارات المدوية هو اليمن. فبعد الانتصار الأول للحوثيين عام 2014 بإسقاط الدولة، ها هم يحتفلون بالعام السادس للانتصار على التحالف العربي. لا يهم إذا كان اليمن قد فقد التحكم في حدوده الجوية والبحرية والبرية. ولا يهم إذا كان هناك أكثر من 20 مليون فقير في البلد. ولا يهم إذا كان البلد بسبب “النصر الإلهي” يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. معايير النصر والهزيمة لا علاقة لها بالإنسان، ولا علاقة لها بالواقع. إنها تأتي من عالم آخر معزول عن أي قيمة أو معيار.
من هذا العالم المفارق جاء الانتصار الأخير في غزة. البعض يقول انتصرت “فلسطين”. والبعض يقول انتصرت “المقاومة”. والبعض يقول انتصر “محور الممانعة”. تم تدمير غزة وتشتيت انتباه العالم عن عدالة مطالب حي الشيخ جراح والعنصرية الممارسة ضد فلسطينيي 1948، لكن البحث عن مبررات للانتصار ليس صعباً، و زراعة أوهام جديدة ناتجة عن الانتصار الوهمي أسهل من شربة ماء. لقد انتصرنا وصارت فلسطين أقرب إلينا من أي وقت مضى. كيف أصبحت أقرب ولم يتغير شيء سوى عدد القتلى من الأطفال والآباء والأمهات؟
أحد معاني كلمة “النصر” في القواميس العربية هو الانتقام من الخصم. ولأن العربي يعيش في إحساس دائم بالذل أمام إسرائيل والغرب يبحث عن أي نوع من الانتقام حتى لو كانت تكلفته باهظة. هنا يصبح إطلاق صواريخ محدودة التأثير تتسبب في أضرار مادية بسيطة لدى “المهزوم” ودمار شامل لدى “المنتصر”، نصراً معنوياً مدوياً.
لكن المشكلة ليست لغوية بالتأكيد. ظل السياسي العربي قومياً كان أو يسارياً أو إسلامياً، يؤمن بحتمية النصر لا بواقعيته ومتطلباته. سننتصر لأن ذلك من حتميات التاريخ لا لأننا نمتلك مقومات النصر! لهذا لم تستوعب حتميتنا هزيمة 67 وظل إيماننا أعمى بأن النصر آتٍ.
أما بالنسبة إلى الإسلاميين (حماس، الحوثيين، الإخوان) فالنصر عندهم إلهي (إنما النصر من عند الله)، وبالتالي لا علاقة له بالقوة العسكرية أو الاستعداد البشري. العامل الوحيد للنصر هو علاقتك بالله وقدرتك على لعب دور وكيله الحصري على الأرض. وإذا كان القاموس القومي قد اخترع بدائله اللغوية التخديرية للهزيمة (نكبة، نكسة، عدوان) فإن القاموس الديني الإسلامي له بدائله التخديرية أيضا (ابتلاء، امتحان، اختبار، محنة…).
ينتصر الزعيم العربي دائماً، لذلك تبدو حياتنا مجرد سلسلة من الهزائم…
منقول عن موقع درج.